الحديث عن التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية حديث قديم متجدد، حيث إن تناول تلك القضايا والاهتمام برصد ودراسة ومكافحة تأثيراتها السلبية قد تعرفنا عليه وقمنا بدراسته فى سنوات العمر الأولى، فقضايا التلوث البيئى والتصحر والحفاظ على السلالات النادرة من الحيوانات والنباتات واستعراض سبل حمايتها من الانقراض من خلال مكافحة وتجريم صيدها، وتشمل الجهود أيضا الحفاظ على المساحة الخضراء على سطح الكوكب من التناقص، بل والعمل على زيادتها قدر الإمكان، من خلال إطلاق حملات لمكافحة الاعتداء على الأشجار والغابات، كما تشمل أيضا حماية الشعاب المرجانية فى قاع البحار والمحيطات، وكذا أيضا مكافحة التلوث البيئى الناجم عن مخلفات المصانع وغيرها من القضايا التى مررنا عليها مرور الكرام ولكنها علقت فى أذهاننا كإحدى القضايا التى ربما لم نشعر بأهميتها وخطورتها فى ذلك الحين.
استمر الوضع على الوتيرة نفسها حتى كان عام 1985 عندما تعرفنا لأول مرة على ثقب الأوزون(1) وخطورة اتساعه، وهو ببساطة عبارة عن ثقب فى غلاف الأوزون الذى يحيط بالكرة الأرضية، وهو الذى يعمل كغطاء واق للأرض والكائنات الحية من أشعة الشمس الضارة، وهنا بدأنا نستمع إلى الحملات التوعوية التى تتحدث عن الأسباب المساعدة على اتساع هذا الثقب ومن ثم زيادة الخطورة، فجاء فى مقدمة تلك الأسباب الانبعاثات الناجمة عن عوادم السيارات ومداخن المصانع وباقى المخلفات الكيميائية الأخرى الصادرة عن المصانع أيضا، وصولا إلى الإشارة إلى انبعاث غاز الفريون الموجود فى المبردات وأجهزة تكييف الهواء وخلافه، ولا ننسى بالطبع الخطورة الشديدة الناجمة عن تلك الانبعاثات الصادرة عن المفاعلات النووية والنفايات الذرية المتخلفة عنها ومن التجارب النووية المختلفة. ومع تزايد الحديث عن هذا الثقب وتأثيراته الضارة، انتشرت العديد من الحملات التوعوية بالأمر وخطورته وسبل المكافحة والحماية لتحجيم حجم الثقب وضمان عدم اتساعه وكذا أيضا ضمان عدم تكرار وجود ثقوب أخرى فى طبقة الأوزون فى مناطق أخرى من العالم بالطبع من أجل الحفاظ على التوازن البيئى والحياة السليمة لكافة الكائنات الحية، وخلال تلك الفترة ظهرت العديد من التحذيرات من تعرض الإنسان لأشعة الشمس المباشرة، خاصة فى أوقات معينة من اليوم ولفئات عمرية محددة، وهو ما صاحبته حملة دعائية للترويج للعديد من المنتجات اللازمة للحماية، مثل الكريمات للوقاية والنظارات الشمسية وخلافه، بالإضافة إلى إصدار عدد من الدراسات الطبية للربط بين هذا الأمر وزيادة حالات سرطان الجلد، كما تم سن عدد من القوانين لتجريم الممارسات التى من شأنها المساهمة فى زيادة حجم المشكلة.
ثم كان المؤتمر الذى نظمته الأمم المتحدة عام 1992 من أجل البيئة والتنمية والمعروف بقمة الأرض(2) بمدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل بمشاركة 172 دولة، والذى أسفر عن الخروج بالإطار العام لمحددات تم الاتفاق على صياغتها فى شكل اتفاقية سميت باتفاقية كيوتو، التى تم توقيعها فى مؤتمر كيوتو باليابان عام 1997، حيث نصت على وضع التزامات قانونية للحد من الانبعاثات الناجمة عن أربعة غازات دفيئة ومجموعة من الغازات الأخرى، حيث وافقت الدول الصناعية الكبرى على خفض تلك الانبعاثات عن النسب المرصودة عام 1990 بقيم تتراوح بين 5% إلى 10% .
واستمرت الجهود المرتبطة بالتغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، وتأثيراتها المختلفة حتى عام 1995 حيث عقد مؤتمر الأطراف Conference of the parties، لأول مرة فى برلين(3) فى الفترة من 28 مارس حتى السابع من أبريل، حيث يعتبر هذا المؤتمر هو الهيئة الإدارية العليا للعديد من الاتفاقيات الدولية فى مجال التغيرات المناخية وتلوث البيئة، منها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، واتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومكافحة الفساد، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، واتفاقيات التنوع البيولوجي، واتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، واتفاقية روتردام بشأن تقاسم المسئوليات وتبادل المعلومات حول المواد الكيميائية الخطرة، واتفاقية كيوتو السابق الإشارة إليها وغيرها من الاتفاقيات المرتبطة بالمناخ.
وبغض النظر عن الخلفية التاريخية لمؤتمرات الأطراف وصولا إلى مؤتمر الأطراف المقبل COP 27(4) والمزمع عقده بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، والذى يتوقع أن يكون المؤتمر الأكبر على الإطلاق من حيث أعداد الدول والمشاركين من الأطراف المهتمة بقضايا تغير المناخ من القطاع الحكومى والخاص ومؤسسات المجتمع المدني-متوقع أن يصل الإجمالى إلى 30 ألف مشارك بحسب تصريحات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد(5)-فإن القضية التى سيتم تناولها هنا هى الإشكالية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجدلية الفائدة والضرر من استخدام تلك التقنيات فيما يرتبط بمدى اتساق جهود التحول الرقمى مع الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة أن تلك التقنيات قد تم اعتمادها كحل وحيد لاستمرار الأعمال واستمرار دوران عجلات الاقتصاد العالمى خلال الفترة الأولى من انتشار وباء كورونا. والآن، ومع انحسار موجات الوباء، عادت الأصوات تتصاعد بوجوب العودة إلى الأساليب التقليدية لأداء الأعمال فيما طالبت أصوات أخرى بضرورة اعتماد أدوات التحول الرقمى على أساس أن العالم بعد كورونا لن يكون كالعالم قبل كورونا ولا يجب أن يكون، ثم سرعان ما بدأت الموجة السادسة من الوباء تنتشر حول العالم مما أدى إلى تراجع الأصوات الداعية إلى عودة الأساليب القديمة مرة أخرى وهو ما يبدو أنه سيكون الصراع والجدل المستمرين خلال السنوات القليلة المقبلة على أقل تقدير.
الثورات الصناعية وأصابع الاتهام:
قبل أن نبدأ فى توجيه أصابع الاتهام إلى العصر الصناعى بأنه المتسبب فيما وصلت إليه الأمور من مشكلات بيئية يظهر أثرها المناخى ولا يستطيع أحد أن ينكره، دعونا نسرد الثورات الصناعية الأربع والتى بدأت عام 1784 والتى بدأت فيها الميكنة على استحياء مع استغلال طاقة البخار وبداية مصانع النسيج فيما عرفت بالثورة الصناعية الأولى، والتى استمرت فيها تلك الأدوات فى التطور، ومع دخول الطاقة الكهربائية فى المعادلة والتحول إلى الإنتاج الكمى الكثيف، ومع ابتكار خطوط الإنتاج فى المصانع، يمكن القول إن الثورة الصناعية الثانية قد بدأت عام 1870 واستمرت حتى عام 1969، والذى يعتبر هو بداية الثورة الصناعية الثالثة حيث بداية التشغيل الآلى للمصانع ودخول الحاسب الآلى والبرمجيات إلى تلك الصناعة، ثم انتقال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشمل كافة مناحى الحياة وهى التى تطورت تطورا كبيرا مع انتشار شبكة الإنترنت وتطبيقاتها المختلفة، وكذا أيضا التطور الكبير الحادث فى وسائل الاتصالات من كوابل ألياف ضوئية وأقمار صناعية وتطور سرعات المعالجات المركزية بالحواسب الآلية Central Processing Unit /CPU وسعات التخزين المتاحة وصولا إلى تقنيات المعالجة والتخزين المتطورة والمعروفة بالحوسبة السحابية Cloud Computing، مع انتشار استخدام الهواتف الذكية وصولا إلى نحو 6.6 مليار هاتف ذكى، وانتشار شبكات التواصل الاجتماعى ووجود نحو 4.95 مليار مستخدم لشبكة الإنترنت عالميا مع زيادة سرعات تلك الشبكات وصولا إلى الجيل الخامس G5 وابتكار تقنيات جديدة مثل إنترنت الأشياء Internet of Things /IoT حيث تمتلك كل الأشياء فى حياتنا قابلية الاتصال بالإنترنت أو ببعضها بعضا لإرسال واستقبال البيانات لأداء وظائف محددة من خلال الشبكة.
ومع هذا الكم الهائل من البيانات أصبح للذكاء الاصطناعى اليد العليا والكلمة الأولى والأخيرة فى بزوغ فجر الثورة الصناعية الرابعة التى قد يعتبر البعض أنها بدأت منذ عام 2016 بحسب تصريح كلاوس شواب(6) رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادى العالمى World Economic Forum /WEF والذى نجد فيه مصطلحات وتطبيقات للذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد والطائرات المسيرة (Drones)، والحوسبة السحابية وتحليل البيانات العملاقة أو الكبيرة Big Data Analysis، وهى كلها أدوات وتقنيات تنقل الصناعة من المرحلة الثالثة المعتمدة على الآلات التقليدية أو التى لا تعتمد بنسبة كبيرة على البرمجيات وتعتمد بصورة أكبر على العمالة البشرية، وتدخلها فى العملية الإنتاجية إلى الثورة الصناعية الرابعة حيث يتقلص التدخل البشرى بصورة كبيرة مفسحا المجال للبرمجيات والروبوتات للقيام بالأعمال بصورة أكثر سرعة ودقة وذكاء أيضا.
عودة إلى تقسيم الثورات الصناعية إلى أربعة أقسام والتى لا يعنى وجود استحداث أحدها أنها تجب أو تلغى ما قبلها من ثورات، فبالرغم من أن بعض الثورات هو تطوير لما قبلها فإن هذا الأمر يشمل ملمحين رئيسيين هما:
• الملمح الأول: عدم انتشار تقنيات الثورات الأخيرة فى كل دول العالم بالمعدل نفسه، وحيث تتوقف مظاهر الثورات عند حدود الثورة الصناعية الأولى أو بالكاد تقطع شوطا متواضعا فى استخدام تقنيات الثورة الصناعية الثانية.
• الملمح الثاني: الذى يؤكد على عدم إمكانية فصل الثورات الصناعية عن العصر الزراعى الذى قد يعتبره البعض مجازا هو عصر سابق لعصر الثورات الصناعية، وفى الحقيقة فإن استفادة هذا المحور من الثورات الصناعية لا يمكن إغفاله فعلينا دائما أن ننظر إلى تعاقب العصور بمنطق أن العصر التالى يستفيد من مخرجات العصر السابق ويعتمد عليها تماما، مثلما هو الحال فى الثورات الصناعية الأربع ومدى اعتماد كل ثورة على ما سبقها من ثورات، وبصفة خاصة السابقة لها مباشرة.
قبل أن نستطرد فى الاستدلال على المشكلة وأسبابها وتوقيت ظهورها ثم الانتقال إلى توجيه أصابع الاتهام نحو قطاع أو صناعة بعينها، يجب أن نشير إلى إحدى بديهيات ظاهرة التغيرات المناخية ألا وهى أن الارتفاع فى متوسط درجة حرارة الأرض يتناسب طرديا مع كم انبعاثات الغازات الدفيئة Greenhouse Gases، والتى يشكل غاز ثانى أكسيد الكربون(7) نسبة 76% من إجمالى الانبعاثات (الصناعية والزراعية) لتلك الغازات، كما يشكل غاز الميثان نسبة 16%، ثم أكسيد النيتروز والناجم عن استخدام الأسمدة الزراعية والوقود الأحفورى بنسبة 6%، ثم فى النهاية نسبة 2% لعدد من الغازات التى تحتوى على مادة الفلورين وتسمى Fluorinated Gases، وعليه فإن الارتفاع فى درجات الحرارة والمرتبط بتلك الانبعاثات هو الصفة الأساسية لما يعرف بالتغيرات المناخية Climate Change.
وللتأكيد على أن العالم بالفعل يتجه نحو المزيد من الارتفاع فى درجات الحرارة كما يشير مقال منشور على موقع جامعة أكسفورد(8) بعنوان «ثانى أكسيد الكربون وانبعاثات الغازات الدفيئة» CO2 and Greenhouse Gas Emissions، والذى يأخذ متوسط درجات الحرارة حول العالم فى الفترة من 1961 وحتى 1990 كنقطة الصفر، حيث يتضح أن درجات الحرارة بداية من عام 1850 كانت أقل من هذا المتوسط بنحو 37 درجة. ثم استمرت فى الازدياد البطيء أو ربما المستقر حتى بدايات القرن العشرين، حيث استمر الارتفاع معقولا مع الصعود والهبوط حول هذا المتوسط حتى عام 1988، حيث استمرت منذ ذلك الحين الارتفاعات بصورة مستمرة حتى وصلت إلى 74. درجة فوق هذا المتوسط بحلول عام 2019، والحقيقة أن المتوسط العام لارتفاع درجات الحرارة عالميا الذى يتم الإشارة إليه كلما كان الحديث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على ارتفاع درجات الحرارة حيث يشار إلى أن الارتفاع فى حدود من 1 درجة إلى 1.2 درجة مئوية، والحقيقة أن هذا المتوسط لا يوضح حجم المشكلة أو مدى تأثيرها، فالملحوظة الأولى هو أن معدل التغير فى درجات الحرارة يختلف من منطقة لأخرى. فبعض المناطق انخفضت بها درجات الحرارة -مناطق صغيرة جدا فى بعض المحيطات- فيما ارتفعت درجات الحرارة فى بعض المناطق بمقدار 7 درجات، كما أن معدلات ارتفاع درجات الحرارة على اليابسة هى ضعف المعدلات عند المناطق المائية مع أن التركيز الأكبر لمناطق الارتفاع موجود فى القطب الشمالى وقارة أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر من باقى مناطق العالم، ولهذا التوزيع أكثر من دلالة: أولها أن هذا يدل ويتسق مع أن تلك الدول هى الأكثر مساهمة فى الانبعاثات الحرارية المشار إليها، كما أن ارتفاع درجات الحرارة بالقطب الشمالى وتلك المناطق يهدد بذوبان الثلوج وغرق بعض المناطق الشاطئية حول العالم.
يأتى على قمة الدول المساهمة فى هذه الانبعاثات: الصين(9) بنسبة 26.1%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13.4%، ثم دول الاتحاد الأوروبى مجتمعة بنسبة 7.6%، ثم الهند بنسبة 6.5%، ثم روسيا بنسبة 5.6%، ثم اليابان بنسبة 2.6%، يليها البرازيل بنسبة 2.1%، أما عن توزيع نسب الانبعاثات على القطاعات المختلفة(10) فإنه يمكن تقسيم تلك الانبعاثات على أربعة قطاعات رئيسية هى: الطاقة، والزراعة، والتصنيع المباشر، والمخلفات كما يلي:
أولا- الطاقة:
تشمل الاستخدامات فى القطاع الصناعى وقطاع النقل والمبانى بنسبة 73.2% من إجمالى الانبعاثات مقسمة فرعيا كما يلى:
1- 7.2% فى مصانع الحديد والصلب.
2- 3.6% فى مصانع الأسمدة والأدوية والمبردات وتقطير البترول والغاز الطبيعي.
3- 1% فى الصناعات الغذائية والتبغ.
4- 0٫7% فى مصانع الألومنيوم، والنحاس، والرصاص، والنيكل، والتيتانيوم.
5- 0٫6% فى مصانع الورق والمصابيح الكهربائية.
6- 0٫5% من إنتاج المعدات المختلفة.
7- 10.6% من الصناعات التعدينية، والغزل والنسيج، والأخشاب، وصناعة وسائل النقل مثل السيارات.
8- 11.9% الانبعاثات الصادرة عن وسائل النقل المختلفة على الطرق وتمثل وسائل نقل الركاب 60% من تلك النسبة.
9- 1.9% انبعاثات ناجمة عن حركة الطائرات.
10- 1.7% انبعاثات ناجمة عن وسائل النقل البحري.
11- 0٫4% انبعاثات ناجمة عن السكك الحديدية.
12- 0٫3% انبعاثات ناجمة عن أنابيب نقل الغاز، والبترول، والمياه، والبخار.
13- 10.9% انبعاثات ناجمة عن التدفئة والأجهزة المختلفة بالمنازل.
14- 6.6% انبعاثات ناجمة عن التدفئة والأجهزة المختلفة بأماكن العمل.
15- 7.8% انبعاثات ناجمة من المفاعلات النووية وطاقة الكتلة الحيوية.
16- 3.9% انبعاثات ناجمة عن استخراج البترول والغاز وتسريبات أنابيب النقل.
17- 1.9% انبعاثات ناجمة عن التسريب أثناء البحث والتنقيب عن الفحم.
18- 1.7% انبعاثات أثناء استخدام الماكينات فى الزراعة وصيد الأسماك.
ثانيا- قطاع الزراعة:
1- 0٫1% انبعاثات ناجمة عن حصاد المراعى والمحاصيل العشبية .
2- 1.4% انبعاثات ناجمة عن باقى حصاد أنواع المحاصيل.
3- 2.2 % انبعاثات نتيجة إزالة الغابات والاعتداء على أشجارها.
4- 3.5% انبعاثات ناجمة عن حرق مخلفات المحاصيل مثل قش الأرز وخلافه.
5- 1.3% انبعاثات نتيجة زراعة الأرز.
6- 4.1% انبعاثات نتيجة استخدام السماد النيتروجيني.
7- 5.4% انبعاثات نتيجة استخدام السماد العضوى الصادر عن الماشية.
ثالثا- التصنيع المباشر:
1- 3% انبعاثات من مصانع إنتاج الأسمنت.
2- 2.2% انبعاثات ناجمة عن عملية تصنيع البتروكيماويات، مثل إنتاج الأمونيا وعمليات التبريد الصناعية.
رابعا- المخلفات:
1- 1.3% المخلفات السائلة الناجمة عن الإنسان، والحيوان، والنبات.
2- 1.9% الانبعاثات الناجمة عن المخلفات الصلبة الحيوية.
هل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تساهم فى الانبعاثات الضارة؟
الإجابة الأولية عن السؤال السابق هى بالتأكيد نعم تساهم أجهزة ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الانبعاثات الضارة لاشك، ولكن دعونا قبل أن نستطرد فى هذا الأمر نقوم بتحليل النسب المذكورة فى الفقرة السابقة والتى توضح أن أكبر أربع نسب من تلك الانبعاثات هى من نصيب وسائل النقل المختلفة، والصناعات التعدينية، وصناعات الغزل والنسيج، والأخشاب، بالإضافة إلى الانبعاثات الناجمة عن المنازل وأماكن العمل وهى تمثل مجتمعة نحو40% من إجمالى الانبعاثات، ويأتى على رأسها وسائل النقل، ما يفسر الاتجاه نحو السيارات والحافلات الكهربائية بديلا عن الحافلات التقليدية التى تعمل بالبنزين أو السولار.
أما عن أدوات تكنولوجيا المعلومات فالانبعاثات الصادرة عن جهاز حاسب آلى واحد(11) تصل إلى 175 كيلو جراما من غاز ثانى أكسيد الكربون سنويا، فيما ينتج جهاز الحاسب النقالى Labtop من 40 إلى 80 كيلو جراما سنويا، كما ينبعث نحو 19 كيلو من هذا الغاز من جهاز هاتف ذكى واحد سنويا، وفى الوقت نفسه فإن الانبعاثات الناجمة عن سيارة واحدة(12) تصل إلى نحو 4.8 طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنويا، وبحسبة بسيطة نستطيع القول إن الانبعاثات الناجمة عن سيارة واحدة سنويا تعادل الانبعاثات الناجمة عن نحو 27 جهاز حاسب أو نحو 120 جهاز حاسب آلى نقالى Labtop أو نحو 252 جهاز هاتف ذكى.
و تدحض الأرقام السابقة الفكرة القائلة إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الثورة الصناعية الثالثة والرابعة هى إحدى المسببات الرئيسية لتغير المناخ، وأن عصر ما قبل هاتين الثورتين كان أقل تلوثا نتيجة عدم وجود تلك الأجهزة والمقصود هنا ما قبل عام 1969، ولكن كما قلنا من سابقا، فإن تلك العصور لا يُجبُّ الحديث منها القديم، بل يتكامل معه ويزيد معه العبء، ولا يعنى أيضا أن التقنيات القديمة تتراجع بل فى الحقيقة فإن العكس هو الحادث.
التقدير السابق يمكن النظر إليه فى سياق إجمالى أعداد السيارات حول العالم الذى يقترب من 1.4 مليار مركبة مقارنة بنحو 6 مليارات هاتف ذكى ونحو مليارى جهاز حاسب آلى، وعليه وبحسبة بسيطة فإن أصابع الاتهام لا يجب أن تتجه إلى التقنيات الحديثة على أنها أحد الأسباب الرئيسية خاصة أن الانبعاثات الناجمة عنها ثابتة تقريبا، على العكس من تلك الناجمة عن السيارات والتى تعتمد على نوع السيارة ودرجة كفاءة الموتور ونوع الوقود المستخدم وخلافه.
بالطبع، يمكن التعمق فى هذا التحليل باحتساب إجمالى عدد أجهزة الحواسب وإجمالى أعداد الهواتف الذكية والعادية وحساب نسبة تقريبية لمساهمتها فى الانبعاثات الضارة فى كل من المنزل وأماكن العمل، أو الاسترسال فى عمل جداول مقارنة كبيرة لمقارنة تلك الأجهزة والتى ستصل بنا إلى النتيجة نفسها التى حصلنا عليها من تلك المقارنة البسيطة بين الانبعاثات الناجمة عن جهاز حاسب آلى واحد مقارنة بسيارة ركوب واحدة، ولا يعنى الاستنتاج السابق التقليل من حجم المشكلة ولا إلقاء اللوم على التقنيات الحديثة التى هى أدوات الثورتين الصناعيتين الثالثة والرابعة، ولكن ومع الإقرار بمساهمة تلك التقنيات سلبا إلا أننا يجب أن نوضح الاستخدامات والتطبيقات الحديثة التى تسمح بها تلك التقنيات وتتداخل بها فى باقى المحاور السابق الإشارة إليها للتقليل من مساهمتها فى ظاهرة التغيرات المناخية بشكل فعال.
الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات المناخية.. الفرص والتحديات:
دعونا نستعرض هنا بعضا من الأساليب التى يمكن لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة استغلالها والاستفادة بها من أجل المساهمة فى إعادة التوازن البيئى المنشود والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية طالما تتسم تلك الثورة بالذكاء والفاعلية فى إدارة الموارد المختلفة، وكذا أيضا القدرة على تحليل البيانات الكبيرة Big Data Analysis من أجل صياغات فعالة للقرار على كافة الأصعدة، وقبل أن نستعرض هذا الأمر فإن القراءة السريعة لمساهمة الدول فى تلك الانبعاثات الضارة(13) تظهر أن الدول الصناعية الكبرى تحتل المراكز الخمسة الأولى فى معدل تلك الانبعاثات والدول هى الصين، والولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وروسيا بنسبة 63.6% من إجمالى الانبعاثات، وهى فى الوقت نفسه الدول الأكثر إنتاجا لبراءات الاختراع والابتكار فى مجال الذكاء الاصطناعى وفى تطبيقه أيضا.
والاستعراض السريع لتلك المجالات يمكن إجمالها فى الآتي: 1- التوسع فى إنشاء وتحويل المدن التقليدية إلى مدن ذكية، فنظم الاستشعارات وخاصة المتخصصة فى قياس نسب التلوث وكاميرات المراقبة وباقى المكونات التى تعمل من خلال تقنية إنترنت الأشياء تساهم فى إحداث سيولة مرورية وتقلل من التكدسات، حيث يشير تقرير مكنزى إلى أن اعتماد تلك التقنيات يقلل من زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 20% واعتماد تقنيات الإنارة الذكية للشوارع والميادين.
2- التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة وذلك لتقليل الانبعاثات وكذا أيضا تقليل زمن الرحلة والحد من حوادث الطرق.
3- التوسع فى تحويل المبانى إلى مبان ذكية صديقة للبيئة تعتمد على خوارزميات متقدمة فى إدارة عمليات التبريد والتدفئة والتحكم فى الإنارة وشدتها.
4- التوسع فى اعتماد آليات العمل عن بعد Teleworking، والتعليم عن بعد Distance Learning.
5- التوسع فى اعتماد مكونات الاقتصاد الأخضر(14) والذى يشمل الاتجاه إلى الطاقة النظيفة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء، ويشمل أيضا المبانى الخضراء Green Buildings وزراعة أسطح المبانى لزيادة الرقعة الخضراء، وإعطاء المحفزات المالية المناسبة للمؤسسات للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ويشمل أيضا الزراعة الحيوية والتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، مثل أجهزة الحواسب، والتليفونات المحمولة، وبطاريات الليثيوم، والتوسع فى إنشاء مراكز البيانات الخضراء Green Datacenters فى مكوناتها المادية واستهلاكاتها للطاقة وتقليلها للانبعاثات الحرارية الضارة أيضا.
6- التوسع فى المصانع الذكية(15) Smart Factories، والتى قد تصل بها نسب توفير الطاقة إلى نحو 20% مقارنة بالمصانع التقليدية، وتشمل أيضا إعادة هندسة العمليات الصناعية والاستعانة بالروبوتات الذكية.
بصفة عامة، فإن اعتماد تلك الآليات سيساهم فى تقليل الانبعاثات على المستوى الكلى بنسبة يقدرها الخبراء بنحو 15% من الإجمالى العام على الأقل.
ختامـــًا:
بالرغم من أن نسبة الانبعاثات الكربونية فى مصر(16) لا تتعدى 0٫6% من إجمالى الانبعاثات العالمية إلا أن نسبة 75% من تلك الانبعاثات تأتى فى قطاع الطاقة، الأمر الذى حدا بالحكومة المصرية إلى التوسع فى استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، على سبيل المثال ما يخص طاقة الرياح(17) التى تتميز بها مصر مما جعل مجلس طاقة الرياح العالمى يضعها فى مقدمة الدول العربية التى تمتلك إمكانيات هائلة فى هذا المجال، وهو ما انتبهت إليه الدولة المصرية، فى الآونة الأخيرة، من خلال إنشاء محطات توليد طاقة الرياح العملاقة مثل محطة جبل الزيت، والاتفاق الأخير مع المملكة العربية السعودية لبناء أكبر محطة فى العالم لهذا الغرض، كما شيدت مصر أيضا محطة بنبان(18) وهى أكبر محطة طاقة شمسية فى مكان واحد، حيث تستهدف الدولة وصول نسبة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى 42% بحلول 2035 لتشمل 14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح و21% من الطاقة الشمسية بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية المركزة، هذا أيضا بالإضافة إلى الطفرة المحققة فى قطاع النقل والتى تشمل القطار الكهربائى والمونوريل، وأيضا باقى أعمال التطوير بالسكك الحديد، والموانئ البحرية، وشبكة الطرق، ومنظومة النقل الذكى، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المدن الذكية ويأتى على رأسها بالطبع العاصمة الإدارية الجديدة مع الجهود المستمرة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى المجالات المختلفة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضي، والتى تركز فى مرحلتها الأولى على قطاعات الزراعة، والبيئة، وإدارة المياه، والقطاع الطبي، والتخطيط الاقتصادي، والتصنيع، وإدارة البنية التحتية.
المصادر:
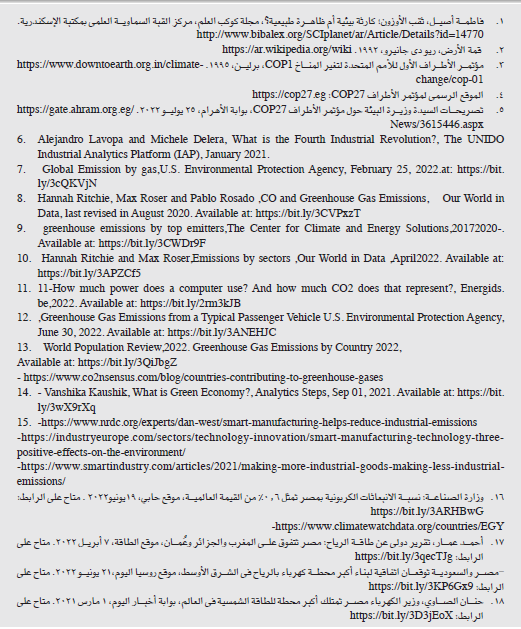
-